دولة صلبة .. وثورة سائلة: فهم المشكل فرع من حلّه
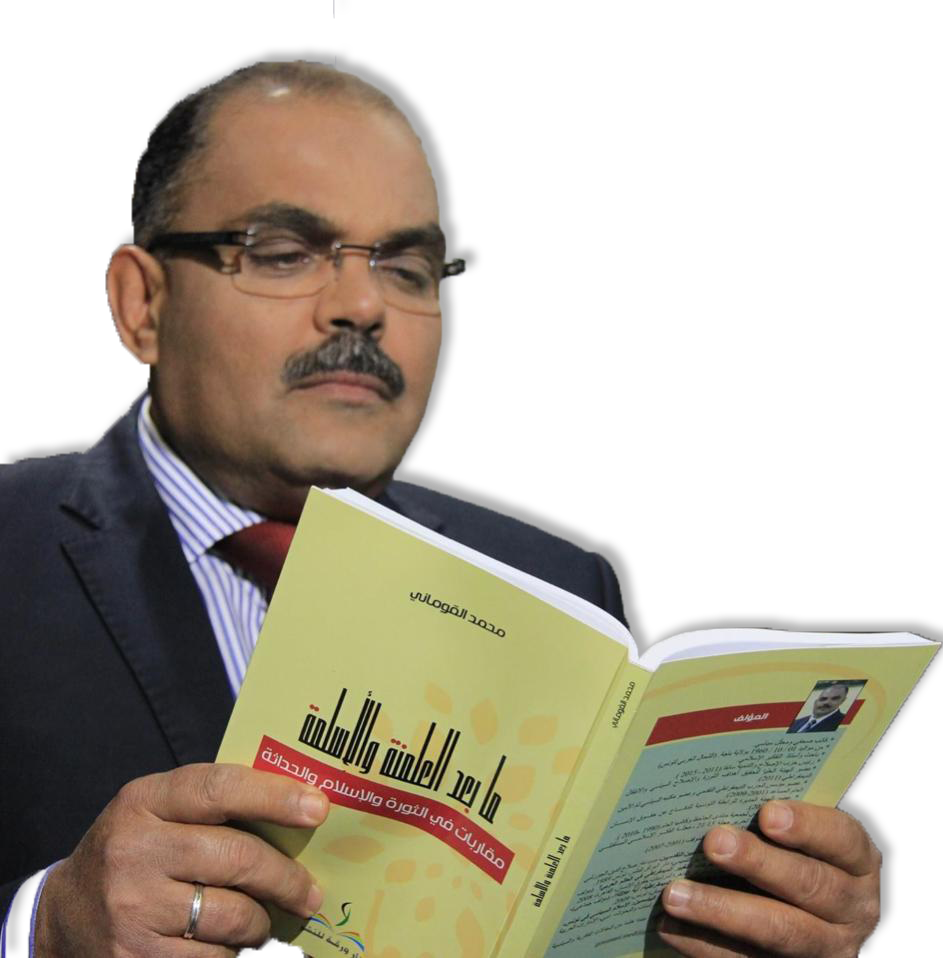
أستعير مصطلحي “الصلب” و”السائل” من عالم الاجتماع البولندي المفكر زيجمونت باومان (1925 – 2017) علّهما يسعفانني في رصد مجموعة من المؤشّرات على تحوّلات نوعية تشهدها بلادنا منذ الثورة. تعود بعض تلك التحوّلات إلى عوامل موضوعية تتّصل بعالم “ما بعد الحداثة”. وتعود أخرى إلى ما يشهده المجتمع التونسي خلال السنوات الثمانية الأخيرة، ضمن جدلية “الدولة الصلبة” كناية عمّا يكتسيه ما كان قائما من عمق وتكلّس واستعصاء عن التغيير، و”الثورة السائلة”، كناية عمّا يعتمل في المجتمع من جديد لم يتخلّق بعد، وما يعتريه من إرادويّة وغموض وتردّد.
استعمل باومان “الحداثة الصلبة” للتعبير عن مرحلة سيادة العقل على كلّ شيء وتحكّم الدولة في الإنتاج والتطور وكبح جماح الأفراد لصالح المجموع. واستعمل “الحداثة السائلة” للتعبير عن تفكّك المفاهيم الصلبة والتحرّر من كل الحقائق والمفاهيم والمقدسات، وتخلّي الدولة عن دورها السابق وفتح السوق أمام الرأسمال الحرّ والاستهلاك، والتحديث المستمرّ الذي لا هدف له إلاّ المزيد من الاستهلاك والإشباع الفوري والمؤقت للرغبات. وقد طالت سيولة باومان “الحياة، والحب، والأخلاق، والأزمنة، والخوف، والمراقبة، والشر”. التي كوّنت كُتبه الثمانية عن هذه الظاهرة. فمفهوم السيولة يعني ببساطة انفصال القدرة (ما نستطيع فعله) عن السياسة (ما يتوجب علينا القيام به). ففي ظلّ السيولة يمكن أن يحدث كل شيء ، لكن لا شيء يمكن أن نفعله في ثقة واطمئنان.
تُعرّف الدولة تقليديا على أنّها مجموعة من الأفراد (الشعب) يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدّد (الأرض/ الوطن) ويخضعون لنظام سياسي معيّن متّفق عليه فيما بينهم يتولّى شؤون الدولة (الحكومة والسيادة). وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها. وتُطرح نظرية العقد الاجتماعي في التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة، الذي يضحّي بموجبه الأفراد بجزء من حريتهم، من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار. ويضيف البعض أنّ الدولة تحتكر العنف (السلاح) وينبغي على الأفراد طاعتها بوصفها الضمان الوحيد ضدّ الاضطراب والفوضى.
ويتبيّن اليوم دون عناء، اهتزاز هذه المفاهيم “الصلبة” للدولة إلى حدّ تفكّكها واضمحلالها. فالثورة الرقمية في الاتصالات والإعلام على وجه الخصوص وتدفّق المعلومات والسّلع، والنقل المباشر لكل ما يحصل في العالم الذي صار قرية صغيرة، وشبكات الشركات العابرة للقارات ومصالح الدول الكبرى، نالت من معانى حدود الأوطان وسيادة الدول، وجعلت المعابر “سائلة”، حتّى صار التحكّم في تهريب البضائع والمخدّرات والسلاح وتنقّل الإرهابيين مستعصيا. أمّا السوق فلم تعد حرّة فقط بل مستباحة، ورأس المال صار متوحّشا.
ومن جهة أخرى فإنّ المناكفات الأيديولوجية والسياسية والاستقطاب الثقافي بين النخب والحرب الأهلية غير المعلنة خلقت سيولة في مفهوم وحدة الشعب، حتى قال بعضهم “لنا تاريخنا ولهم تاريخهم” وغنى آخر “أحنا شعب وهمّا شعب”. والهواتف الذكيّة الشخصية الموصولة على مدار الساعة بشبكة الأنترنيت، التي تضاعفت وانتشرت بعد الثورة وتحرّرت من قيود الاستبداد والحظر، خلقت للأفراد من الشباب أساسا، عوالمهم الخاصة بكل منهم، فصاروا خارج مجال تأثير الإعلام الموجّه للسلطة. بل منحت الثورة الرقمية للأفراد، في وقت قياسي دون تمييز جنسي أو غيره، حريات ومجالات للفعل والاستقلالية تفوق حلم كل المصلحين الاجتماعيين و تستعصي على صرامة كل سلط الرقابة الدينية والمدنية. ولم يعد الواقع الاجتماعي والاقتصادي ينتظر إذنا من أحد لكي يُخرج من أحشائه شيطانا أو ملاكا. وصارت العلاقات سائلة في جميع الاتجاهات وبات سلطان الدولة الصلبة محدودا جدّا. وتطوّرت الجريمة وازدادت مخاطرها على الجميع.
انبنت دولة الاستقلال التي قادها بورقيبة والدستوريون عامة، والتي حقّقت مكاسب هامّة بلا شكّ، على الإلحاق الثقافي والاستبداد والحكم الفردي والمركزية والتفاوت بين الجهات. وكانت تلك أهمّ عناوين معارضتها على مدى عقود، من قبل عائلات فكرية وسياسية مختلفة، ليتراكم النضال، حتَى كانت ثورة الحرية والكرامة سنة 2011.
كان من المؤمّل في ظلّ النهج السلمي للثورة التونسية أن تنفتح دولة الاستقلال على الطاقات التي عانت من الإقصاء والتهميش، وأن تسري دماء جديدة في الحكم مُشبعة بقيم الثورة ووفيّة لأهدافها، حتّى تصحّح الدولة مسارها دون قطيعة أو هزّات لا تتحمّلها، وحتّى تتكامل الأجيال وتلتقي مختلف العائلات الفكرية والسياسية على خدمة مصالح وطنية جامعة، وتتنافس الأحزاب، في إطار التعددية والشفافية، على البرامج والأشخاص التّي تؤمّن تلك المصالح. وأن ينتهي احتكار الدولة من طرف واحد لتكون جاذبة لأبنائها لا طاردة لهم. كما كان على الذين عملوا طويلا في مواجهة الدولة أن يندمجوا في مؤسساتها وأن يعملوا من داخلها.
فالثورة تجبّ ما قبلها، ومن ينخرطون في أهدافها ومسارها، ويلتزمون بدستورها، مهما كانت مواقعهم قبلها ومهما كانت إسهاماتهم فيها، لا فضل بينهم ولا عداوة، وأيديهم ممدودة لبعضهم لطيّ صفحة الماضي بسلبياته ومكاسبه، ولكتابة صفحات جديدة مشرقة من تاريخ تونس. لكن ها نحن نستكمل السنة الثامنة للثورة دون أن يتحقّق الأمل. بل إنّ حزب حركة النهضة على سبيل المثال، الذي كان قمعه وحظره عنوان الاستبداد خلال العقود الأخيرة، لا يزال بعد تقدّمه في الانتخابات ومشاركته في الحكم بعد الثورة ، يُتهم بمحاولة “التسلّل لمفاصل الدولة” ويُعامل ككيان “غريب” بل ويطالب البعض بحلّه وحظره من جديد. لنكتشف أنّ “الدولة الصلبة” تستعصي عن إدماج معارضيها السابقين. وأنّ دستور الجمهورية الثانية والمكاسب السياسية الهشّة للمرحلة الانتقالية، لم تؤمّن بعد، انتقالا ديمقراطيا مُطمئنا. وفي ظلّ تعطّل كيمياء التوافق بين الباجي والغنوشي وبين النداء والنهضة، واستفحال الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية وتصاعد الاحتقان الاجتماعي تزداد المخاوف عن مستقبل “الثورة السائلة”.
فالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يتغذّى من مناخ سياسي بالغ التأزّم، لم يعد يشغل التونسيين وحدهم، بل صار مادّة لمقالات عديدة وتعليقات بمنابر إعلامية عربية وأجنبية، لا تستبعد سيناريوهات فوضى داخلية قد تجد دعما من جهات خارجية، غير بعيدة عن جدلية “الدولة الصلبة” و”الثورة السائلة”. فالأدوية المفقودة، وكذلك الموادّ الغذائية الأساسية على غرار السميد والحليب والبيض، والأسعار الملتهبة، والاحتجاجات المكثّفة، لم تعد خلفياتها السياسية خافية، وتداخل الحقيقي بالمُفتعل فيها، لتـأزيم الأوضاع وإثارة الرأي العام ضدّ الحكومة والأطراف الداعمة لها. ونسبة التشاؤم العالية جدّا في صفوف الشباب خاصة، و”غربتهم” عن “الدولة الصلبة” التي تعكسها أغاني “الرّاب” المنتشرة بينهم، ومشاعر النقمة لديهم على وضع لا يملكون فيه ما يخافون على خسارته، وإقبالهم اللافت على “الحرقة” والمغامرة بحياتهم في البحر، أو حرق أجسادهم للتعبير عن اليأس أو محاولة إشعال نار الثورة مجددا، وغيرها من المؤشرات صفّارات إنذار ورسائل دالّة عن تصادم مفاهيم “الدولة الصلبة” مع الأفكار والاتجاهات السائلة بين شباب جيل جديد لا يرى أنّ ثورة الحرية والكرامة قد أنصفته.
لا مفاضلة بين ما رأيناه “صلبا” أو”سائلا” فيما عرضنا له من تحوّلات لافتة لم تكتمل عناصرها بعد. بل محاولة في التفكيك والتحليل لفهم وتفهّم ما يحصل ببلادنا عسانا ندوّر زوايا النظر في التعاطي مع التحديات التي تواجهنا لتجتمع القدرة مع السياسة على رأي باومان. فلن يفلح التفاؤل المفتعل في التغطية عن الواقع. وقديما قالوا “فهم المشكل فرع من حلّه”.
محمد القوماني
*منشور بجريدة الرأي العام، العدد88، تونس في 27 ديسمبر 2018.
https://scontent.ftun3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/48421483_2250835061606932_5353636872872525824_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.ftun3-1.fna&oh=d41ca8381afcfcdc2b7dc853887cbbc5&oe=5CD2BD29
