من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي:حركة النهضة التونسية تُطوّر معجمها وتُغيّر تموقعها*
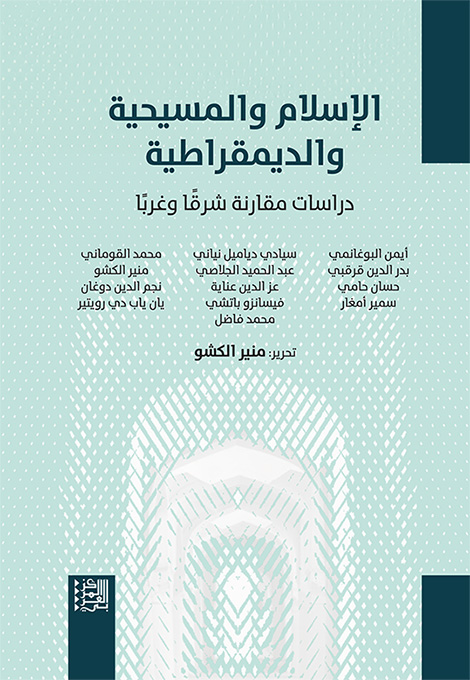
محمد القوماني
مقدمة
خلص البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة في عام 2016، بعد عرض أهمّ مخرجاته، إلى أنّ “حزب حركة النهضة قد تجاوز عمليّا كل المبرّرات التي تجعل البعض يعتبره جزءا مما يسمّى “الإسلام السياسي” وأنّ هذه التسمية الشائعة لا تعبّر عن حقيقة هويته الراهنة، ولا تعكس مضمون المشروع المستقبلي الذي يحمله”[1].
لنر إذا: كيف انتقلت حركة النهضة في تونس من جماعة دينية سرّية في نشأتها إلى حزب سياسي؟ بل كيف تطوّرت من حركة إسلامية، تقبل بنتائج الديمقراطية في تأسيسها إلى حزب ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية مشارك في الحكم بعد الثورة؟ وما الخصائص الذاتية والأسباب الموضوعية التي أسهمت في هذا التطور النوعي الذي جعل حركة النهضة تشكّل أهمّ طرف سياسي وطنيا، وتجربة مميّزة عربيا وإسلاميا؟ ثم ماذا تعني مغادرة النهضة للإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي؟ وماذا يترتّب عن ذلك؟
تتمثل الإشكالية المركزية التي تتصدّى لها هذه الدراسة في الوقوف على مدى نجاح أحزاب ذات مرجعية إسلامية، على غرار حركة النهضة التونسية، في الاستجابة لمقتضيات الدولة الحديثة والديمقراطية ومنظومة حقوق الانسان؟
سنعمل في هذه الدراسة على تقديم إجابات عن هذه الإشكالية من خلال تتبّع خطاب “الإسلام السياسي” الذي يتغذّى من اللُّبس في علاقة “الإسلام بالسياسة” في المجال الثقافي العربي الإسلامي من جهة، وعلاقة “الإسلام بالحداثة” من جهة ثانية، متخذين من حركة النهضة التونسية مثالا. ونعتمد في ذلك منهجا تاريخيا تحليليا من موقع المتابع والباحث، والناشط والفاعل والناقد في آن واحد، ضمن تجربة الجمع بين المثقف والسياسي، وتجربة الانشغال الفكري والانتماء الحزبي، التي نصرّ على مواصلة خوضها.
أوّلا: الإصلاح الديني والإسلام السياسي بين الاتّصال والانقطاع
ساهمت حركة الإصلاح الديني في أوروبا، التي دشّنها اللاهوتي الألماني مارتن لوثر (Martin Luther)، وأحيينا المئوية الخامسة لانطلاقها، (15أكتوبر/تشرين الأول 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017)، في تشكيل عالمنا الجديد من خلال بصماتها فيما نصطلح عليه اليوم بالحداثة. وقد نشأت حركة النهضة العربية والإسلامية الحديثة متأثرة بما جرى في أوروبا، بل كانت صدى لها وجوابا للتحدي الذي طرحته علينا، وصاغه مصلحون مسلمون في السؤال التقليدي: لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ ولذلك جرى الحديث لاحقا عن حركة إصلاح ديني في البلاد العربية والإسلامية، وارتبطت بأعلام معيّنين، تنوّعت مقارباتهم بين القائمة الطويلة للمصلحين عامة، على غرار الأفغاني وعبده والكواكبي ورشيد رضا وعلال الفاسي وابن باديس ومحمد الطاهر بن عاشور، وغيرهم.
اعتبرت “الحركات الإسلامية” التي صارت توصف ب “الإسلام السياسي” نفسها امتدادا لحركة الإصلاح الديني. وقد مثلت علاقة “الديني” ب “السياسي” موضوع خلاف منذ الأفغاني، وكانت سبب فراق بينه وبين تلميذه ورفيق دربه عبده. وكان الربط لاحقا بين رشيد رضا، تلميذ عبده، وبين حسن البنا، مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين”، كبرى الحركات الإسلامية الحديثة، الذي حضر بعض دروس رشيد رضا وحاول استئناف إصدار مجلة “المنار”. ويمكن اعتبار الجامع الواضح بين “المصلحين الدينيين” و”زعماء الحركات الإسلامية”، هو التأكيد على استمرار عطاء الإسلام واعتباره أساس النهضة الإسلامية قديما، وأحد أهمّ أسباب تحقيقها حديثا، من خلال التركيز على أهمية الاجتهاد والتجديد في الفكر من جهة، وإصلاح السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية وأنظمة الحكم من جهة أخرى.
كانت حركات “الإسلام السياسي” ردّ فعل وجوابا فكريا وتنظيميا، على نزعات “العَلمنة” التي قرنت بين المسيحية والإسلام، وحاولت استنساخ ما حصل في أوروبا من فصل بين الدين والسياسة وإبعاد للكنيسة عن الحياة العامة وتقديم العلم بديلا عن الدين.
حيث انتبه روّاد النهضة العربية الإسلامية في القرن التاسع عشر، وكانوا من أصول إسلامية أو مسيحية،إلى الفارق الحضاري الشّاسع الذي بات يفصل مجتمعاتهم عن الغرب الحديث، وطرحوا أسئلتهم بشأن أسباب تأخّر المسلمين، وبلوروا أجوبتهم في أقوم المسالك لمواكبة التحولات العالمية واكتساب مقوّمات التمدّن والتقدّم، لم تغب في اهتمامات هؤلاء الروّاد قضية الديمقراطية بتعبيرات جيلهم، بل كانت في قلب مشاغلهم. فتناولوا قضايا الحريّة والعدل والاستبداد والفصل بين السلطات وعلاقة الدين بالدولة وتقييد سلطة الحاكم بقانون كما هو معروف في أدبيّات الطهطاوي (1801ـ1873) وخير الدين التونسي (1810ـ1890) والأفغاني (1838ـ1897) والكواكبي (1855ـ1902) وعبده (1849ـ1905) وشبلي الشميل (1850ـ1917) وفرح أنطون (1874ـ 1922)، وغيرهم. وكان الاستبداد أهم خصم لروّاد النهضة وأهمّ عائق لها.[2]
وقد بذل هؤلاء الروّاد، من ذوي الأصول الإسلامية بصورة خاصّة، جهودا نظرية مهمّة في التوفيق بين الهوية والحداثة والدعوة إلى الاقتباس من الغرب “دون مخالفة الشريعة”، وفي إثبات عدم التعارض بين الإسلام والمدنيّة والحرية.[3] لكن هذا المنحى التوفيقي لدى الروّاد سرعان ما تراجع خلال القرن العشرين ليفسح المجال تدريجيا لحالة من الانقسام في الوعي والمواجهة الفكرية والسياسية المفتوحة، وأحيانا المصادمات الدامية.
نادى مثقّفون عرب[4]، بالعلمانية، بما هي فصل تامّ بين الدين والدولة واستبعاد الإسلام من المجتمع، ومن الحياة العامّة، واعتباره مسألة فردية، ودافعوا عنها وساندوا فرضها قسريّا باستعمال عنف الدولة من خلال أدوات الحكم. وفي المقابل، أُسّس تيّار آخر من المثقفين،[5] ممن رفضوا هذا المنحى العلماني في التفكير وعملوا على مواجهته سياسيّا، ودعوا إلى التصادم معه ومقاومته بالعنف، إذا لزم الأمر، كما دعا أنصارُ هذا التيّار إلى تحكيم الإسلام واعتماده منهجا شاملا للحياة.
بداية من ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ يتبلور تيار فكري سياسي جديد في مواجهة التيار العلماني، ونعني به التيّار الموصوف اليوم بالإسلام السياسي أو الإسلاميين. ففي عام 1928 أسّس حسن البنا (1906ـ 1949) “جماعة الإخوان المسلمين.” وكان ممّا حدّده لها من أهداف، كما جاء في رسائله، “أن تقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنيّة الغرب، وحضارة المتع والشهوات التي جرفت الشعوب الإسلامية فأبعدتها عن زعامة النبي صلى الله عليه وسلم وهداية القرآن وحرمتها من أنوار هداها”.[6]
ومن بعد البنا الذي اغتيل في عام 1949، ازداد تفكير الإخوان تجذّرا في مواجهة الفكر الغربي والتوجهات العلمانية، حين وصف سيد قطب، الذي أُعدم في عام 1966، الحضارة الحديثة وواقع المسلمين عموما، بما سمّاه “الجاهلية” إذ يقول: “نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كلّ ما حولنا جاهلية، تصوّرات الناس وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم، موادّ ثقافتهم، فنونهم، آدابهم، شرائعهم، قوانينهم، حتّى الكثير مما نسمّيه ثقافة إسلامية، ومراجع إسلامية، وفلسفة إسلامية، وتفكيرا إسلاميا (…) هو كذلك من صنع الجاهلية”.[7] وأخذ قطب عن المفكر الباكستاني أبي الأعلى المودودي، مقولة “الحاكمية لله”، إذ يرى أنّه: “ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع، والمسلمون جميعا لا يستطيعون أن يشرّعوا قانونا ولا يقدرون أن يغيّروا شيئا ممّا شرّعه الله لهم”[8]. وكانت دعوته إلى “الحاكمية لله”، بداية تفرّع جماعات من الإسلام السياسي المختلفة مع الإخوان المسلمين والأكثر تشدّدا في الفكر وفي مناهج التغيير.
يمكن إيجاز أطروحة الإسلام السياسي، مع اختلاف تجاربه، في السياق الذي نحن بصدده، بأنها صراع ضد العلمانية. ومن هنا تبلور شعار “الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة ومصحف وسيف” ردّا على دعوة فصل الدين عن الدولة والحياة العامة. كما كان الإسلام السياسي صراعا مع “الإسلام الشعبي” و”الرسمي” الذي يكاد يحصر الإسلام في الشعائر وقضايا الآخرة. ومن هنا كان شعار “الإسلام منهج أو نظام حياة”. وكان الإسلام السياسي أيضا صراعا مع الأنظمة الحاكمة التي تُمثّل في نظره امتدادا للاستعمار وتطبيقا لحلول مستوردة. وفي هذا الإطار، يتنزّل شعار “الحاكميّة لله”، ويأتي مطلب تطبيق الشريعة وإقامة النظام الإسلامي. وكانت دعوة الإسلام السياسي أيضا إلى إقامة “دولة إسلامية” ردّا عن إلغاء “دولة الخلافة” في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وما تبعها من جدال فكري وسياسي بين المسلمين.
في سياق هذا التقابل الحادّ بين “الغرب” و”الإسلام” و”الحداثة” و”الهوية” ودعاة “الجاهلية” ودعاة “الماضوية”، نفهم الصراع المحتدم في الفكر العربي الحديث والمعاصر الذي تحوّل إلى سجالات أيديولوجية لم يختلف كثيرا بعضها عن بعض في المنهج والخطاب السلفيَين، وإلى اتهامات متبادلة في التخوين والتكفير والعنف، آلت إلى “اغتيال العقل”، بتعبير برهان غليون.[9] وكان ذلك الصراع ضربا من الحرب الأهلية غير المعلنة على مدى عقود، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، حين تشكلت “الدولة الوطنية”، وحدثت تغييرات في الأنظمة السياسية للكثير من البلدان العربية التي أخذت في أغلبها طابعا أيديولوجيا غير خاف.
لعلّ من أسوإ تبعات الصراع بين “الدولة الوطنية” و”الإسلاميين” حصول استقطاب فكري وسياسي وتفقير الممارسة النظرية ونشأة أحزاب من تيارات مختلفة، قائمة على الولاء للزعيم واعتماد الانقلابات العسكرية طريقا للغلبة وتحقيق الأهداف، وانتهاج الإقصاء والتصفية للمخالفين. وفي هذا السياق جرى تفويت الفرص عن أيّة إمكانية لمراجعة الموروث الثقافي واستيعاب الحداثة وتجديد التفكير، لبناء المواطنة أو إرساء الديمقراطية أو تحقيق التنمية أو الدخول في العالميّة. وفي هذا المناخ من الصراع الأيديولوجي والاستقطاب أيضا، جرى الابتعاد كليّا عن منطلقات الإصلاح الديني وأولوياته ومنزعه التوفيقي، فانقطع الجهد ولم تستفد حركات الإسلام السياسي فعليا من جهود المصلحين، ولم تواصل مسيرتهم، بل بدأت مسارا جديدا.
ثانيا: حركة النهضة: مرونة النشأة وانغلاق بعد التأسيس
كان عموم مؤسّسي “العمل الإسلامي” في تونس في نهاية ستينيات القرن العشرين وبداية سبعينياته، شبابا حديثي التخرّج من الجامعة، أو طلاّبا فيها، ولم تكن لهم أدبيات منشورة تحدّد مرجعيّتهم الفكرية. ولم يبرز بين صفوف “الجماعة الإسلامية” كما كانت تسمى في البداية، منذ انطلاقها إلى حدود نهاية الثمانينيات، كُتّاب أو أصحاب إنتاج فكري، عدا حالات محتشمة للغنوشي وعبد المجيد النجار[10]. ولم تصدر عن الحركة (التنظيم) أدبيات فكرية ذات بال.
من الناحية الحركيّة، خاضت النواة المؤسسة للعمل الإسلامي تجارب مختلفة، عكستحالة من التردّد والبحث عن الطريق. فقد سلكت في أعوامها الأولى نهج “جماعة التبليغ والدعوة” ذات الأصول الباكستانية،[11] كما عملت لفترة أخرى ضمن “جمعية المحافظة على القرآن الكريم”،[12] وحاولت لاحقا استنساخ تجربة “الإخوان المسلمين” في مصر، ثم كان التأثّر خلال ثمانينيات القرن العشرين، بالثورة الإسلامية في إيران وبالفكر الاجتماعي لإخوان السودان وبتجارب اليسار التونسي في الجامعة.[13]
إنّ غياب مرجعية فكرية أو حركية مُحدّدة مسبقا، وتعدّد الرموز المؤسسين واختلاف تكوينهم وعدم وجود “مشائخ علم”، كانت عوامل لم تخل من إيجابية، إذ ساعدت على اتّسام “الاتجاه الإسلامي” بدرجة لا بأس بها من التحرّر الفكري وتعدّد الاجتهادات وتنوّع الخطابات، وهو ما عنيناه بمرونة النشأة. وتجلى ذلك أكثر في صفوف قيادات العمل الطلابي في الجامعة خاصة. وساعدت تلك المرونة في انفتاح “الإسلاميين” في تونس، خلافا لتجارب أخرى، على كتابات من مرجعيات متنوّعة، بغرض الاستفادة منها أو في إطار الصراع مع مخالفيهم. لكن هذه العوامل ذاتها، تخلق صعوبة في تحديد الخصائص الفكرية للحركة بصفتها تنظيما سياسيا، بناء على خطاب جامع أو أدبيات مُلزمة.
يبدو أنّ انضمام لجماعة الإسلامية في تونس إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فكريّا على الأقلّ، في ظلّ غموض العلاقة بما يسمّى “التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”، لم يُبن على معرفة كافية ودراسة معمّقة لتجربة تلك الحركة. على الرغم من أنّ حضور فكر الإخوان المسلمين في الساحة التونسية وصدى دعوتهم في الصحافة وفي الخطابات تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، وخاصة من خلال “جمعية الشبّان المسلمين” بتونس[14].
تعامل مؤسسو الجماعة الإسلامية مع “الإخوان” من موقع الانبهار والاستهلاك، وليس من موقع النقد والاستئناس. وقد شكّلت كتابات أعلام من الإخوان المسلمين عل غرار سيد قطب وشقيقه محمد قطب ومؤلفات عبد القادر عودة وفتحي يكن، مادّة أساسية في تكوين الجيل الأوّل من المنتمين للحركة الإسلامية بتونس. لذلك كان نقد الفكر “الإخواني” في مقدمة مواضيع الخلاف الذي عرفته الجماعة مبكّرا، وأدّى إلى تصدّع تنظيمي أُسّس بمقتضاه “الإسلاميون التقدميون”.[15] وكان احميدة النيفر، وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، أوّل من بدأ بنقد الإخوان المسلمين، في إثر لقاء تعرّف خلاله على محمد قطب مباشرة في زيارة إلى مكّة، قبل سفره إلى القاهرة لاحقا للتعرّف إلى جماعة الإخوان من قريب، ثم اطّلاعه على بعض الكتابات الناقدة للإخوان.[16]
تركّز النقد الداخلي على اهتمام الخطاب بالسلوك الفردي وبالمسائل الروحية على حساب نقد المجتمع والدولة والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية، وتمّت الدعوة إلى التفريق بين “الإسلام” بصفته وحيا من قرآن وسنة صحيحة، ثابتا وملزما، و”التراث الإسلامي” بصفته اجتهادا بشريا مرتبطا بظروفه وغير ملزم للأجيال المتعاقبة. كما شمل النقد نظرة الإسلاميين للمرأة ولدورها وموقفهم السلبي من الموسيقى وسائر الفنون، وامتدّ إلى الموقف من الثقافة الغربية ومن الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان وعلاقة العقل بالنقل والفهم المقاصدي للشريعة وغياب التاريخية في فهم النصوص ومسائل أخرى. وقد عكست مجلة المعرفة آنذاك جوانب من بداية هذا التحوّل الفكري الذي انتهى لاحقا إلى تصدّع تنظيمي، ليتواصل النقد ويتعمّق من موقع المنافسة والضغط من الخارج.[17]
كان للنقد الذي باشره “الإسلاميون التقدميون” على نحو واسع، وموضوعه أدبيات الإخوان المسلمين، خاصة من خلال منبر مجلة 15 / 21 في بداية الثمانينات، أثره الواضح داخل الجماعة الأمّ، خاصة في صفوف الاتجاه الإسلامي في الجامعة. وقد عزّز انتصار الثورة الإسلامية في إيران والاطلاع على بعض أدبيات أعلامها، هذا المنحى النقدي، خاصّة فيما يتّصل بضعف الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية،[18] وفتح المجال لبدائل مختلفة. وعكس الغنوشي هذا المنحى، حين وصف فكر الإخوان في تلك المرحلة ب “التقليدي”. إذ يذكر في سيرته الذاتية أنّه “جاءت الثورة الإيرانية في وقت مهمّ بالنسبة إلينا، إذ كنّا بصدد التمرّد على الفكر الإسلامي التقليدي الوافد من المشرق والذي يختصر الصراع في المجتمع في بعد واحد”[19]. وكان نقد الإخوان أو “الفكر الوافد من المشرق” بداية اكتشاف الحركة الإسلامية في تونس لانبتاتها عن الواقع الذي نشأت فيه، والذي تريد تغييره.
في النشأة، لم تؤصّل الجماعة الإسلامية فكرها في حركة الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي التي عرفتها تونس منذ القرن التاسع عشر. ولم يكن أيضا لجامع الزيتونة وأعلامه من المصلحين خاصة، من أمثال سالم بوحاجب ومحمد الطاهر والفاضل بن عاشور أي أثر في الحركة، على الرغم من سبق عبد العزيز بن ميلاد أواسط الستينيات إلى محاولة بعث حركة إحيائية في تونس، وعلى الرغم من وجود زيتونيّين داعمين للجماعة في نشأتها، أمثال عبد القادر سلامة صاحب مجلة “المعرفة” ومديرها، ومحمد الصالح النيفر، المدرّس بجامع الزيتونة. وكان لكليهما ضمن الهيئة التأسيسية ل “حركة الاتجاه الإسلامي” في عام 1981، أثر بالغ في فكر الحركة وتوجهاتها. ويقرّ الغنوشي هذا الانقطاع بوضوح حين يذكر أنّه “لم تكن الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس من ثمار جامع الزيتونة، بل لم يكن للجامع دور يذكر في نشأتها”.[20] وربما عملت الحركة على تلافي هذا الانقطاع أو الاغتراب عن البيئة المحلية وحاولت وصل نفسها بإرث البلاد، خاصة جامع الزيتونة في بداية أواخر الثمانينيات، من خلال بعض البحوث الجامعية لطلاب الحركة، أو من خلال مؤلفات بعض قادتها، خاصة النجار والغنوشي. وصار تبنّي رموز الحركة الإصلاحية التونسية أكثر وضوحا وحضورا وبروزا في بيانات حركة النهضة في نهاية تسعينيات القرن العشرين وفي خطاب قياداتها بعد الثورة.[21]
عموما، كانت علاقة غالبية الإسلاميين بالثقافة المحلّية وبتاريخ تونس المعاصر وأعلامها ضعيفة، وكذلك علاقتها بمؤلفات التونسيين من الجيل الحديث بصورة خاصة.[22] ولعلّ الموقف الحادّ الذي اتخذه الإسلاميون من الرئيس الحبيب بورقيبة، ومن النخبة الحاكمة التي وُصفت ب “المتغرّبة” و”المعادية للإسلام”، والتي كانت تتبنى التراث الإصلاحي، زادت في تغذية هذا الانقطاع عن البيئة المحلية.
اجتمعت عناصر عديدة لتشكّل ضغطا قويّا على قيادة حركة الاتجاه الإسلامي وتدفعها إلى توضيح مواقفها من بعض المسائل الأساسية، لعلّ أهمّها الضغط الذي مارسه الإسلاميون التقدميون والتصدّع التنظيمي الذي عرفته الجماعة في نهاية سبعينيات القرن العشرين، والانسحابات المتلاحقة لكوادر من الحركة خلال الثمانينيات، وتأثيرات الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخميني وخطابها السياسي والاجتماعي الجديد، والتجربة السياسية البراغماتية للحركة الإسلامية في السودان بقيادة حسن الترابي وبعض أفكاره النقدية، والصراع الاجتماعي بين النقابيين والسلطة بتونس في تلك الفترة، ولاسيما أحداث 26 جانفي/يناير 1978، والضغوطات التي مارسها اليسار التونسي على الإسلاميين في الجامعة وإحراجهم بنقد تجربة الإخوان المسلمين، أو في دفعهم إلى الإفصاح عن خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية وتحليلهم للوضع الدولي والإقليمي، وانفتاح الشباب الإسلامي على الكتابات النقدية في الفكر العربي المعاصر، خاصة خلال فترة الفراغ السياسي والفكري التي عرفها الاتجاه الإسلامي بعد اعتقال قياداته أو فرارها إلى الخارج مطلع الثمانينيات، وتوسّع عدد المنتسبين أو المتعاطفين مع الحركة وانضمام كوادر مختلفة التكوين والتطلّعات.
ربّما كانت العناصر “الأكثر محافظة” في القيادة، والأشدّ تأثيرا في التنظيم، أحرص على صياغة وثيقة جامعة تكون مرجعية فكرية للحركة. وهي الوثيقة التي أقرّها المؤتمر العام للحركة في ديسمبر/كانون الأول 1986، أي بعد سنتين من خروج القيادة من السجن عام 1984، واكتملت صياغتها في مطلع عام 1987، ونُشرت لاحقا تحت عنوان “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس”.[23] وجاءت الوثيقة في 34 صفحة من الحجم المتوسط، تضمنت مقدمة في صفحتين، ومحورين في الجوهر، الأول عقائدي، والثاني أصولي منهجي.
أُعدّت هذه الوثيقة الفكرية الرسمية التي أقرّها مؤتمر وجرى نشرها للعموم، وكانت الوثيقة الوحيدة تقريبا، أصلا لضبط الحالة التنظيمية بوضع أساس جامع للانتماء، ولتكون أيضا منطلقا لمن يريد الوقوف على الخصائص الفكرية والخلفيات النظرية لهذه الحركة، اجتنابا لأي تشويه متعمد لمواقفها بتقويلها ما لم تقل. وهو ما تؤكده مقدمتها التي جاء فيها: “نرسم في ما يلي الأسس العقائدية والأصولية لحركتنا حتى تكون معالم نلتقي حولها ونجعلها منطلقا نبني عليه عقيدتنا ونتفاعل به مع الواقع فكرا وممارسة (…) ونحن نقدّر أنّ هذه الأسس العقائدية والأصولية، حقيقة بأن تستنهض همم الكافّة للتفاعل معها بكل رشد وإيجابية وللتعامل من خلالها معنا ككيان واضح الأسس محدّد المعالم”.[24] وكانت وثيقة الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي في مقصدها ومضامينها التقليدية، مؤشر انغلاق بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الاتجاه الإسلامي، مقارنة بطابع المرونة التي صبغت الجماعة في نشأتها.
نكتفي في الاستدلال على المنحى التقليدي في الوثيقة بالإحالة على ما تضمنه المحور العقائدي من الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي في تأكيده أنّ العقيدة هي “الأساس الذي تنساب منه بقية التصورات والأفكار والأحكام”[25] وأن ذلك يقتضي “انبناؤها على اليقين الذي لا يرتقي إليه احتمال ولا يداخله ظنّ”[26]. كما يضيف أنّ هذه العقيدة “نستقي أركانها من القرآن الكريم والسنة المتواترة، ونستقي فروعها من ظواهر الكتاب المعضّدة بما صحّ من أحاديث نبوية مجتمعة”[27]. والأسئلة التي تُطرح في هذا الصدد هي: كيف يمكن أن تكون العقيدة يقينية “لا يرتقي إليها احتمال”، وهي مجرّد استقاء من نصوص، أي تأويل وترجيح وترتيب واجتهاد؟ وكيف اليقين في ظواهر الكتاب وفي أحاديث نبوية تبقى ظنية الثبوت مهما كانت المقاييس؟ وأخيرا، وهو الأهمّ، ما النتائج العملية في السياسة والمجتمع المترتبة على فكر يعتقد أنّه “يقين” وحقّ لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه!؟
في ركن الإيمان، بالله تعالى على سبيل المثال، تنص الوثيقة على أنّ ذلك يقتضي أن “لا يبقى في القلب أدنى مرض وظلمة، ولا في العقل أقل شبهة أو ريبة في وجود الله” وأن “لا يوصف بما توصف به المخلوقات” وأن “وجوده مُباين تمام المباينة للوجود الكوني ذاتا ووضعا” وأن نؤمن “بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم”. وبناء عليه “فإن ألفاظ النصوص المفيدة للتشبيه لا تفهم على ظواهرها بل نضعها في إطار التنزيه المطلق”. [28]
لكن ما جدوى كل هذه التفاصيل العقيدية في الوثيقة؟ ربّما يكون الجواب فيما أشار إليه محمد الهاشمي الحامدي في تقديمه للوثيقة في أوّل طبعة لها حين ذكر أنها تقرّر “عقيدة أهل السنة والجماعة”.
أ مطلوب من حركة النهضة تقرير عقيدة “جماعة،” فتكون أقرب إلى الرؤية “الطائفية” المنغلقة، أم وضع رؤية فكرية منفتحة لحزب سياسي قد ينتمي إليه افتراضيا مواطنون تونسيون من غير المسلمين؟
لئن لم تحظ هذه الوثيقة بالاهتمام اللازم، لا داخل الحركة ولا من المتابعين، نتيجة حالة الصدام بين الحركة والسلطة، التي بدأت في نهاية العهد البورقيبي وامتدت على كامل فترة حكم بن علي[29]، فإنها تعدّ مادة أساسية في تحديد الخصائص الفكرية لحركة النهضة في مرحلة مهمة من تطوّرها، حتّى أنّ المؤتمر الثامن في ماي/آيار 2007 الذي عُقد في الخارج، جدّد التمسك بها. إذ جاء في بيانه الختامي: “جدّد المؤتمرون التزام حركة النهضة بالهوية التي حددتها وثائقها السابقة، والتي تعني الاعتماد على المرجعية الإسلامية وما يعنيه من تقيّد في جميع تصوراتها ومواقفها بما هو معلوم من الدين بالضرورة مُضمنَّا في النصوص الشرعية القطعية مع التوسع في غيرها من الظنّيات بالاجتهاد بشروطه المعتبرة”.[30]
تأتي هذه الإشارة في علاقة غير خافية بما أثارته النصوص الفكرية حول المساواة بين الجنسين وحول حرية المعتقد الصادرة عن “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بتونس” (2005)، التي كانت حركة النهضة أحد مكوناتها، من انتقادات بعض كوادرها الرافضين منحى هذه النصوص وما رأوا فيها من تنازلات تحت ضغط بقية المكونات، وهو ما عدّه البعض نوعا من “الملاحقة الفكرية” التي تُمارس على الحركة من اليسار، بعد الملاحقة الأمنية التي تعرضت لها من السلطة.[31] كما تمّت طباعة وثيقة “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة التونسية” بعد الثورة، ضمن سلسلة “قطوف النهضة“[32] وتولّت الحركة توزيعها مع أدبيات أخرى، من دون أن يشير المؤتمر التاسع الذي عُقد في عام 2012، وهو أوّل مؤتمر علني للحركة بعد الاعتراف القانوني بها، إلى اعتمادها أو التخلي عنها رسميا.
ثالثا: حركة النهضة: من الهاجس الثقافي إلى الحزب السياسي
قدّمت حركة النهضة التي لاحقها الاستبداد على فترات مختلفة من تاريخ تونس المعاصر، ومنع تنظّمها القانوني وشوّه تطوّرها الفكري، وأربك مسارها السياسي، وألحق أذى كبيرا بالمنتسبين إليها، مساهمة فعّالة في النضال من أجل ديمقراطية الحكم، على الرغم من أنّ بيانها التأسيسي في عام 1981 خلا من أيّ ذكر للديمقراطية، ومن أيّ استعمال لمعجم الحداثة السياسية في التعاقد والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، وغيرها.
هذه الحركة التي فازت في أوّل انتخابات حرّة وتعدّدية في تونس في عام 2011، وكانت لها الغالبية في المجلس الوطني التأسيسي، وصدّقت في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014 على كفالة الدولة لحرية المعتقد والضمير ومنع دعوات التكفير، وتخلّت عن مطلب جعل “الشريعة الإسلامية” مصدرا للتشريع التونسي، ما زالت بعد تجربة في الحكم لم تكن سهلة، وفي ظلّ تقلّبات إقليمية وأوضاع تونسية صعبة، بل بالغة التعقيد، تشكّل أهم طرف سياسي وطنيا وتجربة مميّزة عربيا وإسلاميا.
نشأت حركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) في تونس، على غرار سائر التيار الإسلامي، بدءا بتأسيس جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر في عام 1928، في سياق ردّة فعل ثقافية واضحة على تيار “العلمنة” في الفكر العربي الحديث. فكانت دعوة الإسلاميين إلى “أسلمة المجتمع والدولة” تحت عناوين مختلفة أهمها أنّ “الإسلام نظام شامل للحياة”. وغلبت على المرحلة الأولى الدروس بالمساجد والمقالات عبر مجلة المعرفة، وكان مصطلح “الدعوة،” المحبّذ في استعمال الإسلاميين، يختزل استعادة النموذج النبوي وما يعنيه ذلك من اغتراب تاريخي، ومن “تكفير للمجتمع” الموصوف بالجاهلية. وغلب على العمل العفويّة والبحث عن الذات، ولم يُعقد المؤتمر التأسيسي إلاّ بعد عشريّة من العمل في عام 1979، لتنتقل تجربة الجماعة من العفوية إلى التنظّم والعمل ضمن هيكلة مضبوطة بقانون أساسي.
بعد انكشاف تنظيم “الجماعة” في ديسمبر/كانون الأول 1980 للمصالح الأمنية، الذي عكست هيكلته السرية، من “أسرة مفتوحة” و”أسرة ملتزمة”… وتسميات المسؤولين من “أمير” وعامل” و”وكيل” تقليدية الجماعة وانشدادها إلى التراث، جاء القرار بالإعلان عن “حركة الاتجاه الإسلامي” في 6 جوان/حزيران 1981 والتقدم بطلب التأشيرة القانونية. ولم يمنع ذلك الإعلان محاكمة الحركة لاحقا، خاصة بعد انزعاج السلطة من حجمها وانتشارها السريع في المعاهد الثانوية والجامعة.[33]
ورد في مطلع البيان التأسيسي ما نصّه “يشهد العالم الإسلامي، وبلادنا جزء منه، أبشع أنواع الاستلاب والغربة عن ذاته ومصالحه. فمنذ التاريخ الوسيط وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان أمتنا وتدفع بها إلى التخلي عن مهمة الريادة والإشعاع، طورا لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقليات داخلية متحكّمة انفصلت عن أصولها وصادمت مطامح شعوبها. وكان المستهدف الأول طوال هذه الأطوار كلها هو الإسلام، محور شخصيتنا الحضارية وعصب ضميرنا الجمعي”.[34] وهكذا كانت نشأة التيار الإسلامي إيذانا بالتعدّدية الفكرية والتنوّع الثقافي، تمهيدا للتعدّدية السياسية، وكانت شمولية الخطاب الإسلامي جزءا من شمولية الخطابات الأيديولوجية عموما.
لم تكن الديمقراطية من أولويات الإسلاميين ولا من معجمهم، تماما مثل اليساريين والقوميين من منافسيهم، ولا حتّى من مكوّنات خطاب الحكم آنذاك. فقد ذكر الغنوشي في الندوة الصحفية لشرح البيان التأسيسي أن “حركة الاتجاه الإسلامي لا تؤمن بحكم إسلامي ثيوقراطي،” لكنه أضاف أنّ “تصورنا لنظام الحكم ليس تصوّرا ديمقراطيا ولكنه تصوّر شورى”[35]. وكان المشروع السياسي والمجتمعي للجماعة “السرية” قبل ذلك يتمحور حول مطلب مُبهم في تطبيق “الشريعة الإسلامية” وإقامة “البديل الإسلامي”. ولذلك لا عجب أن يخلو البيان التأسيسي للحركة من أيّ استخدام لمصطلح الديمقراطية ولمفردات المعجم السياسي الذي صار يشكّل الخطاب السياسي لحركة النهضة خلال الأعوام الأخيرة، خاصة بعد الثورة.[36] كما خلا أيضا من أيّة إشارة واضحة لإقامة الدولة الإسلامية أو تطبيق الشريعة الإسلامية.
كان “الإسلام” لا الحريات وحقوق الإنسان، على سبيل المثال، هو “المستهدف الأوّل،” كما ينصّ البيان التأسيسي، وكما صارت تعبّر عنه البيانات بعد مواجهة التسعينيات خاصة. وكان الهدف هو “إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة وسلوكا وإعادة الاعتبار للمسجد،”[37] وليس بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية، كما صار الأمر بعد الثورة.
دخلت حركة النهضة في مواجهة مفتوحة مع النظام في نهاية حكم بورقيبة، ومهدت الطريق لانقلاب 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987. ثم كانت المواجهة الثانية والمحنة الكبرى مع حكم بن علي الذي سلّط على الحركة أقسى درجات القمع وسياسة الاستئصال حتى أنهى وجودها تنظيميا بالداخل، وانتقلت قيادة الحركة رسميا إلى الخارج.[38] ولم تبدأ الحركة باستعادة عافيتها نسبيا إلا بعد مؤتمرها السادس في المهجر في عام 1995، الذي أقرّ تقييما معمّقا لمسارها ووقف على أخطائها في المواجهات غير المحسوبة، ونشر ذلك لاحقا في كتاب أبيض تحت عنوان “البيان الشامل.”[39] وكان ذلك المؤتمر إيذانا بنقلة نوعية في المعجم السياسي والخطاب والعلاقات والسياسات للحركة.
أُعيدت موقعة الحركة الإسلامية في بيئتها التونسية في هذا البيان، وجرى تأكيد صلتها بحركة الإصلاح والنضال الوطني والنقابي. كما أُشير إلى مرحلة الثمانينيات والدخول الاضطراري والمستعجل في المعترك الحزبي، ثم في المواجهة السياسية. [40] بل جرى الإقرار على نحو واضح بأنه “وقع استدراج الحركة لمخالفة استراتيجيتها بالدخول قي مواجهة لطالما حاولت تجنبها، حيث اتخذت أثناء مواجهتي 1987 و1991 من الشارع مجالا لتحرّكاتها التعبوية تصديا لعنف الدولة وغطرستها، كما اضطرّ بعض الشبّان للقيام ببعض المبادرات الفردية تمثلت أساسا في استخدام المولوتوف ردّا على مداهمات البوليس وإطلاق الرصاص والاعتقال العشوائي والتعذيب حتى الموت”،[41] وجرت الدعوة في هذا البيان إلى المصالحة الوطنية “والتخلي عن ثقافة التناحر والتصادم والإقصاء”[42].
ذكر البيان أيضا أن الحركة “تجدّد تأكيدها على طبيعتها السياسية المدنية ورفضها لأي ازدواج في الإستراتيجية أو في الخطاب، واعتمادها المنهج العلني السلمي في التغيير، ورفضها استعمال العنف وسيلة لحسم الصراعات السياسية والفكرية ومنهجا للوصول إلى السلطة أو التمسك بها.”[43] وفي هذا التقييم، كما هو واضح، تأشير على بدء مرحلة جديدة وقطع مع سياسات أو ممارسات أملتها سياقات مخصوصة أو تبيّنت عواقبها السلبية. وقد تابعت الحركة هذا التطور عموما في بياناتها للأعوام اللاحقة.
تطوّر الخطاب السياسي لحركة النهضة بدءًا بحرصها على الاندماج السياسي وتطبيع وضعها القانوني بعد مشاركتها غير المباشرة في الانتخابات التشريعية في عام 1989 وتغيير اسمها من ” الاتجاه الإسلامي” إلى “حركة النهضة،” رغبة منها في الالتزام بقانون الأحزاب، بحسب فهم النافذين في الحكم آنذاك والحصول على الاعتراف القانوني. لكنّ التطوّر الكبير حصل بصفة خاصة من خلال مراكمة الوعي بالقمع الذي تعرّضت له الحركة طوال مرحلة نضالها ضدّ الاستبداد، على غرار ما ورد ببيان ذكرى التأسيس في عام 2008 “بعد محاكمات سياسية في صائفة ،1981 ومنذ تلك السنة إلى حدّ اليوم والحركة لا تخرج من محنة إلاّ لتسلّط عليها أخرى، وكل هذه المحن تدور حول ذات القضية وهي قضية الحريات والحق في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي.”[44]
عبر هذا الاستثمار في الديمقراطية والمشاركة في الحركة الحقوقية والسياسية التي مهدت لثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، وأيضا عبر وعي الحركة المتنامي بإكراهات المحيط الإقليمي والدولي، الذي كان غائبا أو ضعيفا إلى حدّ كبير إلى نهاية الثمانينيات، وكذلك من خلال تجربة العمل المشترك مع المخالفين، في المعارضة ثم في الحكم لاحقا، سلكت حركة النهضة طريقها إلى النضج السياسي وطوّرت معجمها السياسي وممارستها.
أقرّت الحركة خلال الأعوام الأخيرة باستفادتها من النقد الذي استهدفها. فعلى سبيل المثال، ورد في بيان 6 جوان 1997 تعليقا على الخلاف مع الإسلاميين التقدميين، “أنّ هذا الأمر قد حسم في مؤتمر 1984 بنص الرؤية الأصولية لحركة الاتجاه الإسلامي، فأغلق هذا الباب الذي كاد يطيح بالحركة واقتصرت الخسارة على بضعة أنفار، إلاّ أن الوجه الإيجابي لذلك الحوار، أو قل الصراع الداخلي هو من الأهمية التي لا يسوغ إغفالها (…) فكان لهذا التمييز بين الإسلام والفكر الإسلامي بين الثابت والمتطور أثر آخر معتبر في تحرير فكر الحركة وانعتاقه من ربقة التقليد، وتأهيله للتفاعل الإيجابي مع تحديات البيئة والعصر وقضاياه مثل قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المرأة والمجتمع المدني والعدالة الاجتماعية، والصراع الدولي ضد قوى الهيمنة، وكذلك قضية التجزئة في أمتنا وما تتطلبه من دعم لكل مسعى وحدوي”.[45]
في بيان 6 جوان/ حزيران 2004، جرت الإشارة إلى أنّ الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس تابعت ما بدأه شيوخ الزيتونة، بل ذكر البيان، أول مرة ، أنّ “أهمّ وثيقة إصلاحية إسلامية أفصح عنها القرن التاسع عشر هي “أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك” بإمضاء الوزير خير الدين التونسي وإن كانت في الحقيقة ثمرة جهد إصلاحي وفكري جماعي بين رجال الإدارة وعلماء الزيتونة”.[46] وفي بيان 6 جوان/حزيران 2006، وعلى خلفية ما كانت تشهده البلاد من حوار فكري وسياسي بعد إضراب18 أكتوبر 2005 الذي شاركت فيه عناصر من حركة النهضة مع آخرين من أطياف سياسية وأيديولوجية مختلفين عنها، جرى التنصيص بوضوح على أنّه “كما لا مجال للتوزيع الحصري لصفات الإسلامية، فلا مجال أيضا للاستئثار بصفات الديمقراطية والحداثة والوطنية. فنحن ندّعي أن لنا وصلا بتلك المشاريع والمطالب، ولا تناقض عندنا بين الإسلامية والديمقراطية، وبين الإسلامية والحداثة، فضلا عن الإسلامية والوطنية”[47].
نحن هنا إزاء تغيّر لا لبس فيه في الموقف، وفي المعجم، مقارنة ببيان التأسيس، فحركة النهضة لا تحتكر صفة الإسلامية كما عبرت عن ذلك منذ عام 1981، إنما ترى نفسها على أرضية الحداثة والديمقراطية، بل هي تعبير عن صيغة مخصوصة “للتحديث على أرضية العروبة والإسلام” في صراع مع رؤية مقابلة “للتحديث على أرضية التغريب والتبعية،” كما تبلور ذلك في وعي قيادات من الحركة وجرى التعبير عنه في وثيقة صيغت في أواخر عام 2010. وأفصحت بوضوح عن أنّ حركة النهضة الجديدة مختلفة عما يعرفه عنها التونسيون قبل 1991.[48]
في بيان 6 جوان/ حزيران 2011، بعد الثورة، أكّدت النهضة هذا التطور المطّرد في وعيها وخطابها، فشدّدت على “التزامها بمقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية التي لا سند لشرعيتها غير ما تستمدّه من قبول شعبي تفصح عنه صناديق الاقتراع عبر انتخابات تعدّدية نزيهة. كما أكدت قاعدة المواطنة والمساواة بين الجنسين أساسا لتوزيع الحقوق والواجبات، كتأكيدها لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.[49]
صار بناء الدولة الديمقراطية وضمان الحريات وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية عناوين المشروع السياسي لحركة النهضة، وليس إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة. وفي كلّ الأحوال، لم يعد التعارض قائما بين الأمرين. كما صارت الحركة تتبنى الانتخابات التعددية والحرة والشفافة أساسا وحيدا لشرعية الحكم الديمقراطي، ولم تعد تفكّر بالمغالبة و”الغلبة” والإطاحة بالاستبداد بأيّة وسيلة، على غرار غالبية القوى الرافضة للدكتاتورية في المرحلة السابقة للثورة.
منذ عام 2013، تخلّت حركة النهضة عن مغازلة أطراف داخلها “للتيار السلفي” والجماعات الراديكالية الإسلامية من أجل التوحّد حول مطلب تطبيق الشريعة ومواجهة العلمانيين. كما أنّها تخلّت عن نهجها في القطيعة السياسية مع المنظومة القديمة من الدستوريين، خاصة الذين كانت ترفض مجرد الجلوس معهم خلال العام الأول من حكم الترويكا، لتصبح من أهم المدافعين عن التوافق الوطني والشراكة السياسية التي لا تقصي أحدا. وكشفت قيادة النهضة عن مرونة سياسية بالغة ودرجة عالية من المناورة، حتى ضحّت بالحكم وخرجت من الحكومة، على الرغم من أنّها كانت الحزب الغالبي في المجلس التأسيسي في ذلك الوقت من أجل التوافق على دستور ديمقراطي وخفض التشنّج السياسي وإنقاذ البلاد من سيناريوهات العنف وإنجاح المسار الديمقراطي. وكان ذلك في خضمّ أوضاع عربية مضطربة.
كان هذا التطوّر المهمّ في خطاب حركة النهضة وفي معجمها السياسي وفي ممارستها الميدانية، الذي عكسته بوضوح واطّراد بيانات ذكرى التأسيس، منذ أواسط التسعينيات، تجاوزا عمليا لنزعة الانغلاق في الرؤية الفكرية والأصولية لأواسط الثمانينيات. ويبقى تثبيت المراجعات والخيارات الجديدة في حاجة إلى جهود نظرية تعمّقه وتجعله متناغما مع المنطلقات والقناعات الفكرية.
رابعا: المؤتمر العاشر للنهضة: من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي
عقدت حركة النهضة مؤتمرها الوطني العاشر في ماي/آيار 2016، بعد تجربة استثنائية في الحكم، وبعد تراجعها في انتخابات عام 2014 إلى المرتبة الثانية. كانت كلّ الفرضيات مطروحة ومتاحة في الشكل والمضمون. اختار النهضويون نهج المراكمة التاريخية والتقييم والإصلاح، واستبعدوا خيار القطيعة مع الماضي والبداية من جديد، فكان هذا المؤتمر محطة فارقة ونُقلة نوعية. واستفادت الحركة من خاصيّة المرونة التي اصطبغت بها في نشأتها الأولى، واستمرت معها خلال مختلف المراحل، على الرغم من نزعات الانغلاق أحيانا، تمدّها بقوّة خارقة على التأقلم والتطوّر، مع المحافظة على وحدتها وجماهيريتها.
جدّد المؤتمر المرجعية النظرية للحركة في لائحة الرؤية الفكرية التي عوّضت الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي، وأشار البيان الختامي إلى “الفهم المقاصدي للمرجعية الإسلامية” والقراءة التجديدية “ضمن المدرسة الإصلاحية التونسية”. وانتهى إلى أن المؤتمر اختار “الحزب الوطني هوية جديدة للحزب (…) تتسع أوعيته التنظيمية للتعدّد والتنوع (…) ويتبنى “الديمقراطية التوافقية والتفاوض والبحث عن كلمة سواء في إدارة شؤون البلاد ولأولوية المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.”[50]
بهذه المراجعات والتوجهات الجديدة، خلص البيان إلى أنّ “حزب حركة النهضة قد تجاوز عمليا كل المبررات التي تجعل البعض يعتبره جزءا مما يسمى “الإسلام السياسي” وأنّ هذه التسمية الشائعة لا تعبر عن حقيقة هويته الراهنة، ولا تعكس مضمون المشروع المستقبلي الذي يحمله”.[51] فتسمية “الإسلام السياسي” ليست من وضع الإسلاميين أنفسهم، بل مصطلح أطلقه باحثون أوروبيون على عموم الحركات الإسلامية، بدءًا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومرورا ببقية الحركات والجماعات، السنية والشيعية، التي جعلت إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية هدفا بعيدا لها.
ليس مصطلح “الإسلام الديمقراطي” هو الآخر من اجتراح حركة النهضة أو الإسلاميين من تجارب أخرى، بل سبق لبعض مراكز البحث الأمريكية (كارنيغي (carnegie) مثالا) استعماله للتمييز بين الحركات الإسلامية المتشدّدة والعنيفة التي تعمل على إسقاط الدولة، والحركات المعتدلة التي تقبل بالمشاركة السياسية والعمل من داخل الدولة. وهذا ما عناه الغنوشي في كلمة الافتتاح للمؤتمر العاشر، حين ذكر أنّ “حركة النهضة لم تتوقف عن التطور خلال مسيرتها الطويلة. تطورت الحركة من السبعينات إلى اليوم من حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية، إلى حركة احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري، إلى حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم الإسلام ملتزمة بمقتضيات الدستور وروح العصر مكرّسين بذلك التمايز الواضح والقاطع بين المسلمين الديمقراطيين وتيارات التشدد والعنف التي تنسب نفسها للإسلام، والإسلام منها براء”. [52]
جاء في البيان الوطني لحركة النهضة وبيانات قائماتها المحلية للانتخابات البلدية في 6 ماي/آيار 2018 في تقديم نفسها للناخبين أنّها “حزب ديمقراطي ذو مرجعية إسلامية”. وهذا التعريف للحركة بنفسها ينقلها من حركة تقبل بالديمقراطية إلى حزب ديمقراطي، ويعزّز حرصها على التمايز من “الإسلام السياسي” بتأكيد أنها جزء من “الإسلام الديمقراطي”. فهي حزب يتبنى قيم الحداثة السياسية من مواطنة وحرية ومساواة وانتخاب وغيرها، ويغتني في الوقت نفسه من معاني كلمات القرآن الكريم المتجدّدة، ومن قيم الإسلام الخالدة، مثل العدل والرحمة والوحدة والتآخي والتضامن والإنسانية، وتعاليمه السمحة وموروثنا الثقافي العربي الإسلامي.
يعني مصطلح الإسلام الديمقراطي أولا التخلي عن مطلب الدولة الإسلامية، وتحكيم الشريعة وشمولية فهم الإسلام بصفته نظاما للحياة على نحو ما كان الشأن في الإسلام السياسي، كما بينا في موضع سابق، ويعني ثانيا التمايز الواضح والقطيعة مع الحركات الموسومة بالتطرف والإرهاب.
يغيّر انتقال النهضة من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي، معجمها ومهامها وأولوياتها وتموقعها أيضا، من كونها جماعة دينية سرية في المنشأ في مطلع السبعينيات، إلى تيار سياسي علني مطلع الثمانينيات، ومن حركة محظورة قبل الثورة إلى حزب قانوني بعدها، ومن حركة احتجاجية ضدّ الدولة إلى حزب مشارك في الحكم يعمل من داخل الدولة على تقويتها وتعزيز أركانها.
يبقى هذا التطوّر المسجّل في المعجم السياسي لحركة النهضة وفي تموقعها هشّا، في ظلّ التردّد الفكري وغياب جهد تنظيري يواكبه بالمراجعة والتأصيل. فهو تطور متفاوت الاستيعاب في صفوف القيادة، فضلا عن القواعد. وكشفت بعض المحطات أو المواقف ضعف القناعة بذلك التطور أو مخالفة الممارسة للمصرّح به، ما جعل خصوم النهضة يشكّكون باستمرار في صدقيتها ويتّهمونها بالازدواجية، إذ تبدو المراجعات على الصعيد الفكري صعبة جدّا، ويسود فيها التردّد وعدم الانفتاح على قراءات جديدة في الفكر الإسلامي المعاصر.
لم تغيّر المراجعات التي أنجزها قياديون بالحركة، في أواخر عام 2010، كثيرا من ملامح الرؤية الفكرية/الأصولية، خلافا للمقاربة السياسية وللمعجم السياسي. فقد جرى التشديد على أنّ الحركة حافظت “في منهج فهمها للإسلام على الإيمان بأن أحكام الإسلام تشمل مناحي الحياة كلّها وتغطّي بالبيان كل ما يتعلق بالإنسان من تصوّر وعمل، حيث لا يبقى من الحياة شيء إلاّ والتعاليم الإلهية لها فيه بيان وتوجيه”،[53] فشمولية الإسلام في فهم الحركة تعني “قيّومية الوحي على كل مجالات الحياة”.
لذلك تظلّ حركة النهضة مشدودة إلى النصوص ومناهج فهم الإسلام أكثر من انشدادها لمعارك الواقع وقضاياه بما يتبع ذلك من مخاطر “التكفير”، ودون إدراك للتغيّرات الجوهرية في الحياة الحديثة التي يحتلّ فيها الدين مكانة مهمة في حياة الفرد والمجتمع، ولكن في حيّز مختلف عمّا كان عليه في الأزمنة السابقة وبفهم مختلف للنصوص التأسيسية. وتلك من أهمّ المسائل التي تحتاج إلى المراجعة في رؤية الحركات الإسلامية عموما. ولعلّ اختلاف تصريحات القيادات النهضوية أحيانا، والجدال الداخلي كلّما تعلّق الأمر بمسائل دينية خلافية، تعدّ مثالا دالاّ على التردّد الفكري وصعوبات النقلة النوعية.
خاتمة
في خاتمة هذه الدراسة، يمكننا تسجيل الاستنتاجات التالية:
1 ـ إنّ التصويت لمصلحة حركة النهضة في أوّل انتخابات تعدّدية وشفافة بعد الثورة، ومنحها المرتبة الاولى في المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات عام 2011، كان مكافأة لها على صمودها في وجه نظام الاستبداد، واعترافا بتضحياتها وإسهامها في مراكمة النضال حتى قيام الثورة وانتصارها. وكان هذا التصويت في الوقت نفسه إعلان مأزق الإسلام السياسي وبداية نهايته. فقد أدركت حركة النهضة، حينما تحمّلت أعباء الحكم، أنّ المطلوب إقامة “دولة ديمقراطية” وليس “دولة إسلامية”، وأنّ شعار “الإسلام هو الحلّ” لا يفصح عن دستور توافقي لجمهورية ثانية، يضمن الحريات والحقوق ويرسي دعائم الحكم الديمقراطي والحوكمة الرشيدة، ولا يقدّم أيضا أجوبة عن أسئلة التنمية والتشغيل والتفاوت بين الجهات وتوفير التمويل اللازم لتطبيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وأنّ الشرعية السياسية داخليا وخارجيا لا تمنحها صناديق الاقتراع لوحدها، وأنّ شروطا وطنية وإقليمية ودولية ضرورية على هذا الصعيد.
2 ـ تشكو حركة النهضة من فقر فكري وضعف في الإنتاج النظري لا يتناسب مع حجمها السياسي وحضورها الثقافي والاعلامي. وتبدو مشاكلها مع عموم النخب التونسية، ممّن أسهموا في حكم الدولة الوطنية خاصة، وراء ضعف مقبوليتها في أوساط عديدة. فمؤلّفات الغنوشي والنجار في العقود السابقة تبقى على كثرتها وأهميتها، في غالبيتها أقرب إلى مرحلة الإسلام السياسي، ما يجعل المرحلة الجديدة من الإسلام الديمقراطي، تبدو بلا فكر ولا تنظير، والحال أنّ الحركة الإسلامية انتشرت من قبل فكريا، في أوساط الشباب خاصة، قبل أن تصبح رقما سياسيا مهما قبل الثورة وبعدها. وهذا خلل يحتاج إلى معالجة.
3- لا مستقبل إيجابي لحزب حركة النهضة، إلاّ في المضي بشجاعة وصدقية ووضوح في القطع مع الإسلام السياسي الذي أبان عن حدوده البنيوية وعوائقه. ولا غنى عن جهد فكري في المراجعة والنقد والتنظير واستشراف المستقبل. فالحداثة السياسية ليست مجرد شعارات. والمواطنة والديمقراطية والحريات الفردية والمساواة والغيرية والتمييز بين الدين والسياسة وغيرها من المفاهيم، تحتاج الى مواكبة للتطورات المعرفية والتطبيقية العالمية على هذا الصعيد، والقيام بعملية حفر ضرورية في الذهنية الجماعية، للقضاء على معوّقات التحديث والتطور في جذورها الفكرية، وإعادة تشكيل الوعي، بما يقتضيه تطوّر حركة النهضة وتموقعها الجديد.
4- حركة النهضة ليست رائدة في إدراك عوائق الاسلام السياسي وضرورة تجاوزه وشقّ طريق جديد، فقد سبقها الى ذلك إسلاميون آخرون على غرار أحزاب في المغرب وفي تركيا. وإنّ نجاح حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة أردوغان، في تجاوز الاسلام السياسي، قد جرى بحسن فهم الواقع وإعطاء الأولوية للاقتصاد وخدمة الناس وتقديم البرامج المقنعة لنهضة الأتراك، من دون التخلي عن الانتصار للهوية الإسلامية لتركيا والتشجيع على تديّن الأفراد والمجتمع، ما جعل قطاعات واسعة من الناخبين يصوتون لحزب العدالة والتنمية في محطات انتخابية متتالية بعد أن لمسوا نجاحه في قيادتهم وتحقيق نهضة بلادهم، بل يخرجون للتصدي لمحاولة الانقلاب العسكري على حكمه. وإنّ حركة النهضة التونسية، المتأثرة إيجابيا بالتجربة التركية، مدعوّة الى السير بشجاعة أكبر في هذا الاتجاه. وقد يكون الإسلام الديمقراطي، صياغة وقتية، تهيّئ لتحوّل حركة النهضة التونسية إلى “حزب المحافظين الاجتماعي” على سبيل المثال. فالنهضة ذات القاعدة الانتخابية الواسعة من المحافظين المُفَقّرين والمهمشين بالأحياء الشعبية، مدعوة أيضا إلى توخّي الوضوح في خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب مع هذه القاعدة الانتخابية.
5 ـ لم تكن حركة النهضة لتبلغ هذا المستوى من التطوّر الملحوظ لولا استفادتها من النقد الذاتي، ومن النقد الذي استهدفها في مختلف مراحلها، من داخل الساحة الإسلامية ومن خارجها. وكان مؤتمرها السادس بالمهجر في عام 1995 محطة فارقة في تطوّرها، وهو المنحى الذي تعزّز في المؤتمر العاشر في عام 2016.
على الرغم من أهمية كلّ ما تحقّق على صعيد المراجعات المستمرة، ظلّت بعض الأسئلة بلا أجوبة مقنعة، وظلّت شبهات تُثار حول حركة النهضة. ونحسب أنّ أجواء المناكفات، والملاحقة الفكرية والسياسية المتواصلة، لم تتح فرصة نقد ذاتي بحجم أخطاء النهضة في المعارضة أو في الحكم. وما يصدق على النهضة ينسحب على غيرها من العائلات السياسية، ولاسيما من الدستوريين واليساريين والقوميين. وتلك من معوّقات بناء الثقة بين الفاعلين السياسيين./.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دراسة قُدّمت في الندوة العلمية الدولية تحت عنوان: الإصلاح السياسي والإصلاح الديني بين تجربتي الديمقراطية المسيحية والإسلام السياسي: سجالات، مقارنات، استشراف “، والتي أُقيمت في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2018، ونشرت أعمالها تحت عنوان: “الإسلام والمسيحية والديمقراطية: دراسات مقارنة شرقا وغربا”، تحرير: منير الكشو، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط1، 2024.
ونتطلع إلى دراسة جديدة تكمل المشهد ، خاصة إثر التطورات الحاصلة بعد 25 جويلية 2021 واعتقال قيادات أولى من حركة النهضة وتجميد أنشطتها عمليا.
المراجع
ـ الأفغاني، جمال الدين، الأعمال الكاملة للأفغاني، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1979.
ـ الأنصاري، محمد جابر، تحوّلات الفكر والسياسة في الشرق العربي (1930ـ1970)، سلسلة عالم المعرفة 35، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1980.
ـ أيّ مستقبل لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي؟، القاهرة، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2008.
ـ البنا، حسن، مجموعة رسائل الإمام الشهيد. القاهرة: دار الاعتصام. د.ت.
ـ التونسي، خير الدين، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق منصف الشنوفي، تونس، ط2، الدار التونسية للنشر،1972.
ـ الجورشي، صلاح الدين، الإسلاميون التقدميون : التفكيك وإعادة التأسيس، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2010.
ـ الجورشي، صلاح الدين، ومحمد القوماني وعبد العزيز التميمي، المقدمات النظرية للإسلاميين التقدميين، تونس، دار البراق للنشر، 1989.
ـ الحامدي، محمد الهاشمي، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس، لندن، ط 1، دار الصحوة للطباعة والنشر، 1987.
ـ جركة النهضة، بيانات ذكر التأسيس، سلسلة قطوف النهضة 1، منشورات حركة النهضة، جوان 2012.
ـ حركة النهضة، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة التونسية، سلسلة قطوف النهضة 2 تونس، منشورات حركة النهضة، 2012.
ـ حركة النهضة، المسيرة والمنهج، سلسلة قطوف النهضة 4، تونس، منشورات حركة النهضة، 2013.
ـ حركة النهضة، حركة النهضة (2010): الأرضية الفكرية ونظرية العمل وملامح المشروع، سلسلة قطوف النهضة3 ، تونس، منشورات حركة النهضة، 2013.
ـ حركة النهضة، الاتجاه الإسلامي وبورقيبة، محاكمة من لمن؟، سلسلة قطوف النهضة 5، تونس، منشورات حركة النهضة، 2013،
ـ حركة النهضة، لوائح المؤتمر العاشر لحركة النهضة، تونس، منشورات حركة النهضة، ماي 2017.
ـ الطهطاوي، رفاعة رافع، تخليص الإبريز في تلخيص باريز، الأعمال الكاملة للطهطاوي، تح محمد عمارة، مج 2، بيروت، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنش، 1973.
ـ عبده، محمد، الأعمال الكاملة للإمام والشيخ محمد عبده، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط1، دار الشروق، 1991.
ـ غليون، برهان ، اغتيال العقل. بيروت، ط1، دار التنوير، 1985.
ـ الغنوشي، راشد، من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، دار المجتهد للنشر والتوزيع، مطبعة تونس الثانية، 2015.
ـ قطب، سيد، معالم في الطريق. بيروت ـ القاهرة، دار الشروق، د.ت.
ـ القوماني، محمد، “المشروع الثقافي للإسلاميين: اغتراب الخطاب وشكلا نية التحول”، مجلة 15/21، العدد12، 1985.
ـ القوماني، محمد، “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس” ، مجلة 15/21، العدد 19، جوان 1989.
ـ الكواكبي، عبد الرحمان، الأعمال الكاملة للكواكبي، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1975.
ـ من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس. دبي، ط. 1، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2011.
ـ المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام السياسية، القاهرة، لجنة الشباب المسلم، 1951.
ـ الهذلي، عبد الرحمان، جمعية الشبان المسلمين بتونس والحركة الوطنية (1939 ـ 1959)، منشورات مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة الدراسات التاريخية، عدد23، تونس، 2022.
الهوامش
[1] ـ حركة النهضة، لوائح المؤتمر العاشر لحركة النهضة، تونس، منشورات حركة النهضة، ماي 2017، ص 276.
[2] ـ ينظر على سبيل المثال: قول عبد الرحمان الكواكبي: “وقائل آخر يقول: الشرق مريض، مريض، وسببه فقدان التمسك بالدين، ثم يقف. مع أنّه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأنّ التهاون في الدين ناشئ عن الاستبداد. وأنّ العافية المفقودة هي الحرية السياسية”. عبد الرحمان الكواكبي، الأعمال الكاملة للكواكبي، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1975، ص148.
[3] ـ قال بذلك خاصة:
ـ رفاعة رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، الأعمال الكاملة للطهطاوي، تح محمد عمارة، مج 2، بيروت، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنش، 1973.
ـ خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق منصف الشنوفي، تونس، ط2، الدار التونسية للنشر،1972.
كما عُرف هذا المنهج التوفيقي عن جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده. ينظر: جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة للأفغاني، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1979.، محمد عبده، الأعمال الكاملة للإمام والشيخ محمد عبده، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت، ط1، دار الشروق، 1991.
[4] ـ بدأت روافد التيار العلماني مسيحية على أيادي شبلي الشّميل وفرح أنطون على سبيل المثال، ثم توسع التيار ليشمل روافد إسلامية. ينظر:
ـ محمد جابر الأنصاري، تحوّلات الفكر والسياسة في الشرق العربي (1930ـ1970)، سلسلة عالم المعرفة 35، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1980، صص13. 14.
[5] ـ ـ نعني هنا بصفة خاصة أعلام “الإسلام السياسي” ومنظريه مثل أبي الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب وعبد القادر عودة وغيرهم.
.[6] ـ حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد، القاهرة، دار الاعتصام، د. ت، ص26.
[7] ـ سيد قطب، معالم في الطريق، بيروت ـ القاهرة، دار الشروق، د. ت، ص ص 21-22.
[8] ـ أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام السياسية، القاهرة، لجنة الشباب المسلم، 1951، ص16.
[9] ـ برهان غليون، اغتيال العقل، بيروت، دار التنوير، ط1، 1985.
[10] ـ تكثّفت إصدارات كل منهما أثناء إقامتهما بالخارج بصفة لاجئين سياسيين منذ نهاية الثمانينيات.
[11] ـ جماعة تعتمد الوعظ والدعوة المباشرة للناس في أماكن وجودهم المختلفة وتتجنب الخوض في المسائل السياسية والخلافية. ينظر:
ـ راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، دار المجتهد للنشر والتوزيع، مطبعة تونس الثانية، 2015، ص37.
[12] ـ جمعية تونسية معترف بها، تعمل داخل المساجد، لا تتجاوز أهدافها ما تدل عليه تسميتها من اهتمام بتحفيظ القرآن الكريم ومتعلّقات هذا الهدف.
ـ احميدة النيفر، “شهادة عن سنوات التأسيس”، في: من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس، دبي، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط1، فيفري 2011، ص112.
ـ راشد الغنوشي، م. س، ص53.
[14] ـ ينظر:
ـ محمد ضيف الله، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة منوبة، تونس. (استشهد بمقتطفات من جريدة الصباح ضمن محاضرة غير منشورة).
[15] ـ صلاح الدين الجورشي، الإسلاميون التقدميون: التفكيك وإعادة التأسيس، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع،2010، ص134 وما بدها.
[16] ـ الجورشي، م. ن، ص40..
[17] ـ صلاح الدين الجورشي ومحمد القوماني وعبد العزيز التميمي، المقدمات النظرية للإسلاميين التقدميين، تونس، دار البراق للنشر، 1989.
[18] ـ جرى الإقرار بتلك التأثيرات لاحقا ينظر: بيان الذكرى 19 لحركة عام 2000، في: جركة النهضة، بيانات ذكر التأسيس، سلسلة قطوف النهضة 1، منشورات حركة النهضة، جوان 2012، صص97،98.
[19] ـ الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، م. س، ص55
[20] – م. ن، ص41.
[21] ـ يبدو التركيز واضحا على تبيئة حركة الاتجاه الإسلامي بتونس في الأدبيات الرسمية للحركة بعد التقييم المنجز بالخارج خلال المؤتمر السادس في عام ،1995 وهو ما عكسه بيان الذكرى 15 في 6 جوان/ حزيران 1996 وما تلاه من بيانات في الأعوام اللاحقة خاصة في البيان المطول جوان/حزيران 2004.
[22] ـ محمد القوماني، “المشروع الثقافي للإسلاميين: اغتراب الخطاب وشكلا نية التحول”، مجلة 15/21، العدد12، 1985، ص ص36. 40.
[23] ـ محمد الهاشمي الحامدي، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس، لندن، دار الصحوة للطباعة والنشر، ط 1، 1987.
ونشرتها حركة النهضة بعد الثورة. ينظر: حركة النهضة، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة التونسية، سلسلة قطوف النهضة 2 تونس، منشورات حركة النهضة، 2012.
[24] نكتفي بوضع ما نقتطفه من الوثيقة بين ظفرين، دون الإشارة إلى الصفحة أحيانا، نظرا لصغر حجم الوثيقة.
[25] ـ حركة النهضة، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة التونسية، م. س، ص7.
[26] ـ م. ن، ص. ن.
[27] ـ م. ن، ص. ن.
[28] ـ م. ن، ص ص 7. 8.
[29] ـ محمد القوماني، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس، عرض ومراجعة، مجلة 15/21، العدد 19، جوان/حزيران، 1989، ص ص 24ـ32. (وهي أول دراسة نقدية للوثيقة، أُعيد نشرها مع تحيين وتعديلات في دراسة لنا بعنوان: “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي عند حركة النهضة”، في “من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس”، م. س، ص275ـ 307.
[30] ـ كان ذلك في تفاعل مع الحوارات الجارية مع الأحزاب “العلمانية” في “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات”.
[31] ـ محمد القوماني، حركة 18 أكتوبر: نجح الإضراب وتعثرت الحركة، في: أيّ مستقبل لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي؟، القاهرة،منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2008 ، ص97.
[32] ـ حركة النهضة، الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي، م. س.
[33] ـ حركة النهضة، الاتجاه الإسلامي وبورقيبة، محاكمة من لمن؟، سلسلة قطوف النهضة 5، تونس، منشورات حركة النهضة، 2013، ص29.
[34] ـ ينظر: حركة النهضة، بيانات ذكرى التأسيس، م. س، ص11.
[36] ـ يقارن بين نص “البيان التأسيسي/ جوان 1981 وثيقة تأسيس النهضة في عام 1987 والقانون الأساسي لحركة النهضة في عام 2011. ينظر: م. ن.
[38] ـ حركة النهضة، المسيرة والمنهج، سلسلة قطوف النهضة 4، منشورات حركة النهضة، تونس، 2013، ص10.
[39] ـ ينظر أهم ما في هذا التقييم في البيان المطوّل في الذكرى 15 للتأسيس، حركة النهضة، بيانات، م. س، ص ص 57 ـ 90.
[42] ـ م. ن، ص 69.
[44] ـ م. ن، ص 159.
[45] ـ م. ن، ص 98.
[46] ـ م. ن، ص 130.
[47] ـ م. ن، ص 151.
[48] ـ ينظر: حركة النهضة، حركة النهضة (2010): الأرضية الفكرية ونظرية العمل وملامح المشروع، سلسلة قطوف النهضة3 ، تونس، منشورات حركة النهضة، 2013.
[49] ـ حركة النهضة، بيانات، م. س، ص 170.
[50] ـ حركة النهضة، لوائح المؤتمر العاشر، م. س، ص 277.
[51] ـ م. ن، ص276.
[53] ـ ينظر: حركة النهضة (2010)، م. س، ص7.
مقالات ذات صلة

تنوير وتحرير: ادّكار آخر في القرآن الكريم
2025-11-28

